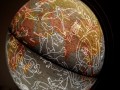الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
مصر وإشكاليات القضية!
مصر وإشكاليات القضية!

بقلم: عبد المنعم سعيد
فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى «يوم الشهيد»، الموافق التاسع من مارس الجارى، لخص الموقف المصرى من حرب غزة الخامسة بأنه يقوم على قدمين: أولاهما الحفاظ على مصالح مصر القومية ومنجزاتها خلال المرحلة الماضية، وثانيتهما تقديم كل العون للشعب الفلسطينى الشقيق فى محنته الخامسة التى بدأت فى ٧ أكتوبر الماضى ولم تنته.
هذا التوازن الدقيق لم يكن هو الحال دائما فى مصر، وفى مطلع القرن العشرين بات معروفا أن هناك «قضية فلسطينية» فى طريقها إلى التكوين نتيجة الجهود الاستعمارية لحل «المسألة اليهودية». كان المؤتمر اليهودى فى بازل قد انعقد فى ١٨٩٧ وتحدث فيه «هرتزل» عن الدولة اليهودية، وصدر وعد بلفور فى ١٩١٧ فى نوع من التحالف ما بين الجماعة اليهودية وبريطانيا الساعية لاحتلال فلسطين، وفرض الانتداب عليها بعد تشكيل عصبة الأمم. وخلال العقدين الأولين من القرن بدأت موجة «الهجرة اليهودية» الأولى إلى فلسطين. الموقف المصرى وقتها من «القضية» كان مساندا للفلسطينيين، لكن الموقف من اليهود كان مرتبطا بالأقلية اليهودية التى تدفقت على مصر فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، لكى تضاف إلى الجماعة اليهودية التى وقفت فى صفوف الثورة العرابية، ومن بعدها ثورة ١٩١٩، وشكلت جزءا مهما من النخبة الاقتصادية فى إقامة بنك مصر، والنخبة الفنية التى شهدت مع وجود الإذاعة والسينما نهضة ثقافية فى مجالات الموسيقى والمسرح والسينما. لم تكن هناك إشكالية فى أن يقوم رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد لطفى السيد، ومعه الدكتور طه حسين، بحضور افتتاح الجامعة العبرية فى القدس عام ١٩٢٤.
كانت مصر تبنى دولتها أو مملكتها الوليدة مع تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ بعد ثورة ١٩١٩ وبعد نضال سلمى، وأحيانا مسلح على طريق الاستقلال من خلال دستور ١٩٢٣ والقوانين الرئيسية للانتخابات وتشكيل البرلمان للقيام بالتشريع للبلاد ونظامها المالى من بنوك ومؤسسات، منها النقابات والجمعيات الأهلية مع افتتاح الجامعات وامتداد الزراعة وقيام الصناعة على أيدى «صنايعية مصر». لم يكن الإنجليز قد خرجوا، فقد كان ذلك يستدعى نضالا استمر حتى عام ١٩٥٦، لكن ما كان يجرى هو صناعة الدولة المصرية كما نعرفها الآن. بالمقابل فى إسرائيل الآن بدأت عملية بناء الدولة خطوة بعد خطوة بالاستيطان وخلق أشكال من الصناعة والزراعة وبناء المؤسسات الحزبية والنقابية والأهلية واستدعاء الهجرات المتوالية واستيعابها داخل كيان صهيونى متقدم. فى المقابل، ورغم الأغلبية السكانية الكاسحة على الأرض الفلسطينية فإن النخبة لم تضع أسس كيان الدولة الفلسطينية فى مشروع وطنى حديث، وإنما كانت هناك إرهاصات للثورة على الاحتلال البريطانى، وبعد ذلك كانت القيادة الفلسطينية قائمة على عائلات تقليدية، كان بينها تناقضات أكثر مما كان لديها اتحاد.
.. الانقسام الذى قام وقتها بين عائلتى الحسينى والنشاشيبى وعائلات أخرى أخذت أشكالا كثيرة لاتزال قائمة. الوحدة التى تمت فى إطار الثورة عام ١٩٣٦ ومع القرب من الحرب العالمية المقبلة شكلت بريطانيا لجنة «بيل» التى طرحت مشروعا لتقسيم فلسطين بعد أن فشلت فى تكوين برلمان مشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين. رفض الفلسطينيون المشروع، بينما قبله اليهود، وهو ما بات تقليدا بعد ذلك عندما عرض قرار تقسيم فلسطين على الأمم المتحدة عام ١٩٤٧.
عقد الثلاثينيات فى مصر كان مشهودا بثلاثة أمور، أولها نضال الشعب المصرى ضد هيمنة القصر الذى أطاح بدستور ١٩٢٣، وثانيها النضال ضد الاحتلال الإنجليزى حتى عقدت معاهدة ١٩٣٦ التى أخذت بالاستقلال المصرى خطوة أخرى فى صناعة الدولة المصرية، وثالثها أن مصر باتت أكثر حساسية لجغرافيتها السياسية، وفى هذا كان الجوار الفلسطينى يفرض نفسه على جدول الأعمال للوطنية المصرية. هذا الأمر رتب تعاطفا شعبيا مع القضية الفلسطينية وبرز ذلك بقوة فى حزب الوفد الذى دفع فيما بعد فى اتجاه قيام الجامعة العربية للدفاع عن استقلال الدول العربية، بما فيها الشعب الفلسطينى. كان كل ذلك طبيعيا فى نمو الدولة المصرية، لكن ما لم يكن طبيعيا كان بزوغ جماعة الإخوان المسلمين المتشحة بعباءة الدين، وتواكب معها ظهور الجماعة الفاشية لمصر الفتاة. الجماعة الأولى جعلت من التناقض الفلسطينى اليهودى قضية دينية ترفض الوجود اليهودى، والجماعة الثانية تطلب الخلاص من اليهود. كلتا الجماعتين خلقت مناخا هستيريا للمواجهة مع اعتقاد عميق بقدرة التفوق السكانى العربى والفلسطينى الذى يتضاعف من خلال ما عرف عن اليهود من جبن شديد. فى ذلك الوقت ولدت الجماعة «الحنجورية» المصرية والعربية أيضا التى تتعامل مع الصراعات الكبرى ليس بالحكمة ومراعاة المصالح الوطنية، وإنما بالدفع نحو مواجهات مميتة وخاسرة.
محاضر مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ المصرى للنظر فى قرار المشاركة فى حرب فلسطين الأولى ١٩٤٨ وكان ملك البلاد يرغب فيها ممهدا لعرش ممتد يخلف الخلافة العثمانية، شهد العديد من الحجج الواقعية التى تجعل الدخول فى حرب استدعاء للخسارة. كانت مصر لاتزال محتلة، مما جعل الاحتلال الإنجليزى هو قضية مصر الأولى فى المحافل الدولية، ومن الناحية العسكرية البحتة لم يكن ملائما عبور الجيش المصرى إلى فلسطين، بينما توجد القاعدة العسكرية البريطانية فى ظهره، ووفق التقدير وقتها فإن الجيش المصرى الذى جرى تقييده منذ الثورة العرابية لايزال فى المراحل الأولى لبناء جديد بعد معاهدة ١٩٣٦. كانت مصر، رغم حداثتها المبكرة، منذ عصر محمد على لاتزال دولة محدودة القدرات، لكنها فى ذات الوقت كانت واعدة بحكم ما حباها الله من قدرات بشرية ومادية، مضافا لها أن الحرب العالمية الثانية، رغم الأوضاع الصعبة، أعطت فرصة للبناء الصناعى والزراعى للنضج نظرا لما سببته الحرب من انقطاع «سلاسل الإمداد» بسبب الغواصات الألمانية فى البحر المتوسط.
ما حدث فعليا أن مصر دخلت الحرب مع ست دول عربية أخرى مع جيش من المتطوعين العرب قدره ألفان، أضيف لهم ١١١ من جماعة الإخوان المسلمين لم يكن لهم أثر، وليس ٤٠٠٠ مقاتل الذين روجت لهم المصادر الإخوانية بالبطولة والفداء. ما حدث عمليا أثناء الحرب أن إسرائيل اعتمدت على تفرق الجيوش العربية بأكثر من وحدتها، واختلاف أهداف الدول العربية من الحرب (راجع كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل «جيوش وعروش»). ومن المدهش أنه رغم التفوق السكانى العربى، فإن الصهاينة حققوا فى كل معركة تفوقا عدديا وفى النيران على من واجهتهم من العرب. وما لم يكن مفهوما أبدا أن جميع خرائط العمليات العسكرية العربية كان هدفها الوصول إلى خطوط قرار التقسيم، فإذا كان ذلك هو الحال فلماذا كانت هناك حاجة إلى الحرب إذا ما جرى القبول بالقرار؟، كانت الهستيريا و«الحنجورية» وغياب الاستراتيجية والنزعات الدينية والفاشية تدفع الشارع فى اتجاه حرب خاسرة، وظل الحال كذلك حتى جاءت «النكسة» فى عام ١٩٦٧، حيث كان ثلث الجيش المصرى فى اليمن، وبعدها عاد الاتزان والنضج إلى الاستراتيجية المصرية!.
GMT 13:37 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
دعم السوريين في بناء ديمقراطيتهم أمر واجبGMT 13:36 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
الخوف صار هذه الناحيةGMT 13:34 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
هل يستمر الصراع على سوريا؟GMT 13:33 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
البيضة والدجاجة في السوشيال ميدياGMT 13:31 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
هل «حرَّر» الشرع إيران من الإنفاق على المنطقة؟GMT 13:30 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
صناعة الاسم والنجم في دمشقGMT 13:29 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
التغيير وعواقبهGMT 13:27 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
صورة إعلان «النصر» من «جبل الشيخ»بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين
لندن ـ عمان اليوم
أعلنت بريطانيا، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ عمان اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيديوتيوب تبدأ اختبار خاصية الرد الصوتي من صناع المحتوى على تعليقات الجمهور
واشنطن - عمان اليوم
تختبر منصة يوتيوب للفيديوهات ميزة جديدة تعزز التفاعل بين صناع المحتوى وجمهورهم، بما يمكن "اليوتيوبرز" من تسجيل مقاطع صوتية كردود على تعليقات الجمهور على فيديوهاتهم. وبحسب صفحة الدعم الفني الرسمية الخاصة بال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©