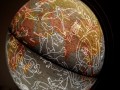الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
شاهد على مصر والقضية الفلسطينية (٩)
شاهد على مصر والقضية الفلسطينية (٩)

بقلم - عبد المنعم سعيد
لم تكن الثمانينات رحيمة لا بمصر ولا القضية الفلسطينية؛ ولكن مصر كان لديها من صلابة الدولة وخبرة التاريخ للتعامل مع الأزمات ما يجعلها تصمد فى مواجهة العزلة التى فرضت عليها من الدول العربية التى لم تقاطعها فقط، أو تنقل المؤسسات العربية بعيدا إلى تونس فحسب؛ وإنما كانت حزمة واسعة من الاتهامات بالنكوص فيما يتعلق بالقضية «المركزية». المدهش أن ذلك حدث بينما كان الوضع العربى فى عمومه يتدهور نتيجة انتقال مركز الاهتمام العربى والدولى من «القضية» إلى حرب تجرى بين العراق وإيران. قبلها، فإن سوريا والعراق وكلاهما محكوم بحزب البعث كان على وشك الصدام المشبع باتهامات التآمر بين الطرفين ومدى أصالته فى تحقيق رسالة الأمة الخالدة. كان انتهاء الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام ١٩٨٢ بالخروج الكامل لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ونقل قياداتها إلى تونس إيذانا بالبعد جغرافيا على الأقل عن تحرير فلسطين. باتت القضية واقعة بين عدة أنواع من الضغوط: أولها أن منظمة التحرير وفى القلب منها تنظيم فتح يواجه بداية التحدى الذى غرسته إسرائيل بتنمية تنظيم دينى - حماس فيما بعد - ينظر إلى الصراع من منظور يختلف عن المنظور الوطنى الذى قامت عليه المنظمة وقيادة الرئيس عرفات. وثانيها أن الشعوب لا تبقى على حالها فى انتظار المعجزات وإنما تقوم بما تقوم به دائما وهو ولادة أجيال جديدة تختلف فى توجهاتها ورؤاها وعلى استعداد ليس للوقوع فى الاختيار المر ما بين التنظيمات الفلسطينية المختلفة وإنما تلجأ إلى الشارع لشن ما بات معروفا بالانتفاضة الأولى.
كنت آنذاك زائرا باحثا فى مؤسسة بروكينجز الأمريكية، وفى السابع من ديسمبر ١٩٨٧ كان إسحق رابين وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك يلقى حديثا فى القاعة الرئيسية فى العاشرة من صباح ذلك اليوم. كان فارق التوقيت بين واشنطن العاصمة الأمريكية والشرق الأوسط قرابة سبع ساعات تحقق فيها واحدة من أنبل اللحظات الفلسطينية التى عرفت فيما بعد بأطفال الحجارة. علق رابين على الموقف بأن حجارة الأطفال ليست زهورا تلقى وإنما أحجارا تميت، ومن ثم فإنه سوف يقوم بتكسير عظام من يتحدون إسرائيل. الأطفال أعطوا لمسات نبيلة لانتفاضة ظهر فيها جيل جديد حاولت فتح بعد ذلك أن ترث انتفاضتهم بالتأكيد على أنها من ميراثها الثورى. ولم تكن مصر وقتها ساكنة، داخليا حاولت استيعاب اغتيال الرئيس السادات بفتح المزيد من الأبواب للإسلام السياسى الذى دخل فى تحالفات برلمانية، مضافا لها تشجيع ما بات معروفا باسم «شركات توظيف الأموال». وخارجيا حاولت الدبلوماسية المصرية تحفيز فكرة عقد مؤتمر دولى للسلام يمثل فيه الفلسطينيون من خلال وفد فلسطينى أردنى مشترك. وفى لندن جرى اتفاق مع «شيمون بيريز» على قبول هذه الصيغة؛ ولكن الحكومة الإسرائيلية المزدوجة جذبت إسحق شامير إلى السلطة وانتهت الفكرة. أصبحت الانتفاضة وبطولاتها واجهة للقضية الفلسطينية جاذبة معها تعاطفا دوليا واسعا يشبه ما تحصل عليه اليوم فى لحظة بدت فيها القضية فى طريقها إلى موات.
أتاحت الظروف وقتها التعرف على الرئيس ياسر عرفات وبعض من العاملين معه كانت بدايته لقاء جرى فى القاعة ٥١٨ فى مبنى الأهرام العريق بترتيب ممن بات فيما بعد صديقا وأخا الأستاذ الكاتب لطفى الخولى. كان الرجل شخصية كاريزمية مؤثرة فى السياسة المصرية والعربية، وأحد قادة اليسار المرموقين. وفى المرة الأولى التى جرى فيها اللقاء سألت الرئيس عرفات عما إذا كانت هناك مراجعة لما حدث فى لبنان وأدى إلى إجهاض المسيرة الفلسطينية. لم يكن الرد مما يسعد فقد كانت هناك الكثير من الملامة لكافة الأطراف ما عدا القيادة الفلسطينية. فيما بعد كانت الحرب العراقية الإيرانية قد وصلت إلى نهايتها فى صيف عام ١٩٨٨، ومع العام التالى طلب منى الدكتور محمد السيد سعيد رحمه الله أن نعد ورقة نستطلع فيها ما يفيد من تجارب حركات التحرر الوطنى التى كانت فى طريقها لتحقيق إنجازات تاريخية مثل جنوب إفريقيا. وفى مناسبة مرور عام على اغتيال الشهيد «أبوجهاد» - خليل الوزير- ذهبنا إلى تونس بدعوة من الرئيس عرفات محملين بورقة التجارب العالمية. وهناك حضرنا الاحتفالات الحماسية؛ وأخذنا أحد القيادات التى لا أذكرها إلى ما سماه غرفة عمليات الانتفاضة؛ وقتها تساءلت كيف يمكن دخول هذه الغرفة لأغراب لا يشاركون فى القرار. لم يكن هناك ما يشير إلى أننا سوف نقابل عرفات ولكن عندما بلغت الساعة منتصف الليل فى يومنا الأخير جاءنا من يقول إننا على موعد للقاء مع شخصية هامة: أبومازن!.
GMT 13:37 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
دعم السوريين في بناء ديمقراطيتهم أمر واجبGMT 13:36 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
الخوف صار هذه الناحيةGMT 13:34 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
هل يستمر الصراع على سوريا؟GMT 13:33 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
البيضة والدجاجة في السوشيال ميدياGMT 13:31 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
هل «حرَّر» الشرع إيران من الإنفاق على المنطقة؟GMT 13:30 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
صناعة الاسم والنجم في دمشقGMT 13:29 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
التغيير وعواقبهGMT 13:27 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
صورة إعلان «النصر» من «جبل الشيخ»بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين
لندن ـ عمان اليوم
أعلنت بريطانيا، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ عمان اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيديوتيوب تبدأ اختبار خاصية الرد الصوتي من صناع المحتوى على تعليقات الجمهور
واشنطن - عمان اليوم
تختبر منصة يوتيوب للفيديوهات ميزة جديدة تعزز التفاعل بين صناع المحتوى وجمهورهم، بما يمكن "اليوتيوبرز" من تسجيل مقاطع صوتية كردود على تعليقات الجمهور على فيديوهاتهم. وبحسب صفحة الدعم الفني الرسمية الخاصة بال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©