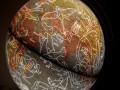الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ماذا بقي لقادة الرأي؟
ماذا بقي لقادة الرأي؟

بقلم : أحمد بن سالم الفلاحي
ابتداء؛ يعرّف قائد الرأي بـ “أكثر الناس تعرضا لوسائل الاتصال، وأكثر ميلا للتجديد”- انتهى النص – وهذا التعريف يعود بنا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كان لوسائل الاتصال التقليدية دورها الأكبر في تحييد الجماهير عن تشرب الرسائل الآتية من هنا أو هناك، من غير وعي، والمسألة مرتبطة كثيرا بنظريات الاتصال التقليدية، التي انتهى زمنها اليوم، في ظل حضور وسائل التواصل الاجتماعي التي ألغت كل الحواجز، وقربت المسافات، وحلقت بالعالم في فضاءات لا أول لها ولا آخر، وبالتالي أصبح مفهوم “قادة الرأي” شيئا من الماضي، أو أنه أوري التراب، كما توارت كل المفاهيم المتعارف عليها في زمن ما، فتصبح من الماضي، أو هي إلى أقرب إلى الذكرى. في أعمارنا الصغيرة؛ في مطلع السبعينيات من القرن العشرين الماضي؛ كان في كل قرانا الصغيرة هناك قائد رأي، تشرئبُّ إليه الأعناق، حيث المُنظّر في كل صغيرة وكبيرة، ويكفي قائد الرأي أن يكون ملما بالقراءة والكتابة، فحيث الأمية تكون؛ يكون التنازل عن الشروط الصعبة للقيادة وغيرها مما لها علاقة بتقاربات المجتمع، ولا ضرورة؛ كما أعتقد؛ أن يكون متبحرا في مختلف العلوم، ولذلك كان هؤلاء الأفراد من أبناء المجتمع لهم القول الفصل في كثير مما يهم القرية وأبناءها، وحياة الناس فيها، وبالتالي فكل أبناء القرية يتجهون إليه في كل صغيرة وكبيرة، لأنه “العارف” وفي زمن متقدم بعد أن كثرت المدارس، وكثر المتعلمون، وعاد المثقفون من غراباتهم، امتلأ المجتمع بقادة الرأي، ولكن هذا الرأي تفرع، وتشعب، وذهب مذاهب شتى، لا أول لها، ولا آخر، حيث أصبحت هذه الفئة؛ وخاصة العائدين؛ متشربين بأفكار أوطان الغربة، وبالتالي لم ينجزوا شيئا مقدرا لحاضر الوطن، بالصورة المأمولة، بقدر ما نظر إليهم على أنهم أصحاب رسالات تغرد خارج السرب، وإن حاول البعض العودة سريعا إلى الحاضنة الاجتماعية المحلية، والتنازل عن بعض مواقفه، وأصبح إلى حد ما ينظر إليه على أنه “قائد رأي” يمكن أن يستمع إليه. في المرحلة الثالثة – الألفية الثالثة – تماهى قادة الرأي؛ وفق المفهوم التقليدي؛ حيث أصبح الجميع بلا استثناء “قادة رأي” ويمكن لأي فرد أن ينظر في كل شيء، وعن كل شيء، وإذا خانته معلومة ما، بضغطة زر على صفحة المعلم “جوجل” سوف تأتيه معلومات المشارق والمغارب، ومنذ القرون الأولى، وبالصور، وبتناقضات الأقوال، واتفاقاتها، فلم تعد المعلومة حكرا على أحد، مهما علا رسمه واسمه، ولذلك تقلصت مجموعة من المفاهيم التقليدية، وعلاقاتها المعقدة، ولم تبق إلا سيادة القانون الذي ينضوي تحت لوائه الجميع، حيث يظل المحدد الأسمى لمختلف العلاقات، وهو الضرورة لأن تكون لكل فرد مساحته الآمنة التي يتحرك من خلالها في علاقاته بالآخر، حيث لا ضرر ولا ضرار. فهذه المراحل العمرية، في مفهوم التحضر؛ التي تمر بها البشرية هي الكفيلة بأن تهدي للحياة صورا نابضة، للفعل والتطور، والنمو، فاستحقاقات الحاضر بأدواته الحديثة لا يمكن أن تقبل تكرار التجربة الإنسانية، فالعصر حاضر بتجربته الإنسانية الآنية، ولا يقبل بتكرار التجارب، وكما يقال: “من ينكر التأريخ؛ يجازف بتكراره” فالذين؛ لا يزالون؛ يشعرون بأنهم “قادة رأي” في أي مجتمع؛ يبقى هذا الشعور؛ نوع من الوهم، حيث يظلون عند شعورهم فقط، فالواقع بكل إرهاصاته لا يمكن أن يراجع نفسه بأدوات تقليدية، ولذلك فردات الفعل التي نراها من أبنائنا؛ أحيانا؛ ونحن نلقنهم مبدأ الخطأ والصواب؛ حسب قناعتنا؛ تبقى ردات فعل متوقعة، وعلينا تفهمهم، وإلا فالصدام حاضر، مهما تكن نتائجه، ونتائجه خاسرة في كثير من المواقف، وإن حدثت تنازلات من الطرفين؛ في بعض المواقف؛ فإنها تقبل على مضض.
جريدة عمان
GMT 19:41 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
مجالس المستقبل (1)GMT 19:20 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
البحث عن مقبرة المهندس إيمحوتبGMT 21:09 2024 الأحد ,04 آب / أغسطس
إسقاط حكومة نتنياهو ضرورة وطنية: مَنْ، كيف ولماذا؟GMT 15:28 2024 الأربعاء ,24 تموز / يوليو
انقلبت الصورة الأميركية: بين من كان على "باب السجن" او "باب الخَرَف"!GMT 15:41 2024 الأحد ,14 تموز / يوليو
موسم انتخابى كثيف!معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستويات معتدلة
مسقط - عمان اليوم
أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يتجاوز 1.4 بالمائة؛ وهو ما يقل عن مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 2.8 بالمائة كمتو�...المزيدأمينة خليل تكشف كواليس دورها في "لام شمسية" وتبكي تأثراً بكلمات الطفل علي البيلي
القاهرة ـ عمان اليوم
حقق مسلسل "لام شمسية" نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2025، حيث حصد المسلسل إشادات وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد، وتحدثت بطلة العمل الفنانة المصرية أمينة خليل عن كوال�...المزيدميتا توسّع قيود حسابات المراهقين في إنستغرام وفيسبوك وماسنجر
واشنطن - عمان اليوم
أعلنت شركة ميتا تعزيز إجراءات الحماية الموجهة للمراهقين عبر منصاتها المختلفة، إذ بدأت اليوم تطبيق قيود جديدة على حسابات إنستجرام للمراهقين، مع توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل منصتي فيسبوك وماسنجر. وكانت ميتا قد طرح�...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ عمان اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©