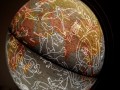الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آثار الانفجار اللامعرفي على العقل العربي!
آثار الانفجار اللامعرفي على العقل العربي!

بقلم : محمد الرميحي
مع التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي تأتيك من كل حدب وصوب، أخبار ومعلومات وآراء قد لا تتفق معها، يذهب البعض إلى لوم وسائل الانفجار الاتصالي، وهو لوم لا فائدة منه، والبعض ينصب نفسه (محامياً) ضد كل ما لا يروق له، أو يعظم ما يتفق معه، وهي عملية مضنية، بل ربما قاتلة. فالقضية لها شقان:
الأول: إن الناس على (قدر عقولها) أو (ذلك قدرهم من الفهم) فلا تتوقع أن يفكر الآخرون كما تفكر، فهم يخضعون، كما أنت، للكثير من العوامل التي تسهم في تشكيل وعيهم بذاتهم أو تأثير البيئة التي يعيشون ويعملون بها، منها التربية وسوية المعرفة التي تعرضوا لها والصداقة والتحيز الاجتماعي أو الثقافي والخلفية العرقية أو الإثنية، أو الخضوع لحالة من الإحباط، والأكثر التحيز السياسي.
لهذا يختلف الناس في تفسير الظواهر التي تصادفهم في حياتهم اليومية، كما يختلفون في قراءة النصوص، ولذلك تجد تلك الاختلافات بين الناس. في الأزمات، وبخاصة السياسية، أو الدينية، ينشأ ما هو ليس اختلافاً فقط، ولكن انشطاراً كاملاً وتفاقماً بين المكونات الاجتماعية إلى حد الخصومة.
أما على صعيد الوطن الواحد، أو على صعيد أوسع، كما يحدث اليوم حول تفسير ما يحدث في غزة. إذاً علينا أن نقبل أن هناك وجهات نظر مختلفة، قد يكون الاختلاف حاداً وقطعياً، كقول البعض في أحداث غزة (إن المقاومة انتصرت على إسرائيل) مثلاً، وأن الفرق هو أيام معدودة حتى تستسلم، أو من يقول إن إسرائيل قد انتصرت نهائياً على المقاومة.
كل ذلك (التطرف أو الإفراط أو الدرجة القصوى من الرأي) وفي تفسير الأحداث، هي ناتجة عن (أهواء)، وخاضعة لعدد من العوامل المؤثرة فيها والتي تقود إلى هذا الرأي أو ذاك، الأمر الذي يزعج البعض في الطرفين، من الرأي الآخر المخالف، كل يرى أنه على حق، وأن الآخر متحيز أو حتى (غير وطني)، لذلك يستخدم بعضنا ألفاظاً حادة كما يستخدم الطرف الآخر ألفاظاً مضادة. وقد يتفاقم الشق المعرفي في السنوات القادمة، حيث ينبئنا العلماء بأن ما سوف نراه من نتائج (الذكاء الصناعي) سيكون مذهلاً، وقد يصل إلى (برمجة عقل الإنسان) والتحكم في تصرفاته!
الثاني: من المعادلة، إذاً ما نحن فيه في إطار التأثير والتأثر، لا مفر منه، فلا يجب أن نلوم بعضنا بسببه، أو نلوم وسائل التواصل، اللوم إن كان ذلك صحيحاً، يجب أن يوجه إلى (آلية نقص المناعة المعرفية) في مؤسستنا، فالكثير من مؤسساتنا التعليمية والأسرية والاجتماعية (العائلية) تربي النشء على أن يفكر في (دوائر محدودة وضيقة).
فعلى الرغم من كل التطور التقني والمعرفي الذي يحيط بنا، وينقل البشرية إلى آفاق لم تكن لتعهدها، لا تزال منظومة التعليم والتدريب والإعلام عندنا باقية كما هي منذ عقود، بل والأكثر أن بعضها أو حتى كثيراً منها يتراجع إلى مقولات تراثية، وبعضها لا يخلو من الشعوذة (والأخيرة بالمناسبة تستخدم التقنية الحديثة لزيادة التضليل)، ما شكل وعياً زائفاً أو مسطحاً يتقبل كل ما يرد إليه من دون فحصه وعرضه على العقل.
من جهة أخرى، وسائل إعلامنا في أغلبها تميل إلى تأكيد الطرق القديمة وشبه المستهلكة في تقديم التحليلات للظواهر التي تحيط بنا، فتزيد الجهل جهلاً، والتعصب تعصباً.
هنا ربما تكمن الإشكالية التي تنتج عقولاً لا تريد أن تنظر خارج محيطها، ويستوي في ذلك صاحب الشهادة العليا (الذي في الغالب لم يحصل على تدريب نقدي) أو الشخص العادي، وتساعد بعض المؤسسات على (بقاء الحال كما هو) من خلال فرض رقابة صارمة على الابداع والتفكير الابتكاري، نتيجة إما من الضغوط الاجتماعية، أو خوفاً على قيم بعينها تعتبرها تلك المؤسسات (مقدسة)، فيخرج الى المجتمع جمهور سهل الانقياد ويشيع التطرف في الفئات وبخاصة الشبابية حيث يسيطر على عقولهم التفكير الأحادي.
في ثقافتنا العربية ومن يتجرأ على الخروج من الدائرة المغلقة ذات البعد الواحد يتعرض إلى نقد غير موضوعي ومحاولة (قتل الشخصية) معنوياً.
GMT 08:32 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
هوامش قمة البحرينGMT 08:31 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
من الميليشيات إلى القبائل: استنبات الثورة وتجريف الهوياتGMT 08:30 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 08:29 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 08:28 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين
لندن ـ عمان اليوم
أعلنت بريطانيا، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ عمان اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيديوتيوب تبدأ اختبار خاصية الرد الصوتي من صناع المحتوى على تعليقات الجمهور
واشنطن - عمان اليوم
تختبر منصة يوتيوب للفيديوهات ميزة جديدة تعزز التفاعل بين صناع المحتوى وجمهورهم، بما يمكن "اليوتيوبرز" من تسجيل مقاطع صوتية كردود على تعليقات الجمهور على فيديوهاتهم. وبحسب صفحة الدعم الفني الرسمية الخاصة بال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©