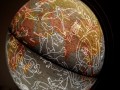الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
تجديد الخطاب الديني مرةً أخرى
تجديد الخطاب الديني مرةً أخرى

بقلم - رضوان السيد
انعقد بمكة المكرمة من جانب رابطة العالم الإسلامي مؤتمرٌ واسعٌ لعلماء الإسلام من مختلف الفئات والمذاهب من أجل التعاون والتضامن وإزالة الحساسيات، ونشر قيم الاعتدال والتسامح والوحدة والتطلع للمستقبل. وقد صارت هذه الملتقيات سُنةً محمودةً شكلت خلال العقود الأخيرة مظلةً في مواجهة تحديات الفرقة والقطيعة والتطرف؛ وبخاصةٍ ما صار يصدر عنها من بياناتٍ ووثائق وعقود تشارك وتعاون بين المؤسسات لجلاء القتام عن وجه الدين الحنيف، واستعادة السكينة ونشر قيم السلم والانفتاح وصنع الجديد والمتقدم.
بيد أنّ الذي أريد تجديد الحديث فيه هو الخطاب الديني العام وكيف تجري صناعته وسط المتغيرات الكثيرة والكثيفة. وهو شأنٌ كبيرٌ يمضي الحديث فيه كل يومٍ على وجه التقريب. ذلك أن المهمات الأساسية لعلماء الدين تتمثل في أربعة أمور: الدعوة لوحدة العقيدة والعبادة، والتعليم الديني، والفتوى، والإرشاد العام. ومؤتمر مكة والمؤتمرات المشابهة تتعلق بالإرشاد العام بالذات. فلا يزال التأثير قوياً ومعتبراً في الأمور الثلاثة الأولى: العقيدة والعبادة، والتعليم الديني، والفتوى؛ لكنه لم يعد كذلك في المجال الرابع: الإرشاد العام. لقد صارت هناك جهات كثيرة في المعارف والإعلام ووسائل التواصل والفضائيات، تملك أجندات لتوجيه المجتمعات، وضاق الحيز الذي يشغله علماء الدين لهذه الجهة للاشتراكات الكثيرة والتحديات الكثيرة من خلال المتغيرات والبرامج والمصالح المتصارعة في المعارف وفي الميول وفي تصورات الحاضر والمستقبل.
ولكي يكونَ واضحاً ما أقصده أذكر تحديات مواجهة التطرف، وتحديات الحوار مع الآخر الديني والثقافي خلال العقود الأخيرة. لقد كانت هناك صعوبات كثيرة سواء في المواجهة أو في التواصل، بسبب نقص المعرفة والخبرة، وبسبب متغيرات العصر والعالم. وقد احتاج الأمر إلى جهود جبارة من جانب الأفراد والمؤسسات حتى انفتحت سُبُلٌ بعد انسداد، وتبلورت شراكاتٌ بداخل المجال الإسلامي ومع عوالم الأديان والثقافات. ولا يزال. الأمر يحتاج إلى عملٍ كثير؛ لكنْ كما سبق القول فإنّ المجال انفتح؛ لأنّ الاحتياجات صارت ضرورات، وتتنامى المعارف لدينا بشأنها دونما توقف.
هناك مشكلاتٌ نوعيةٌ الآن، يقف الخطاب الديني أمامها عاجزاً أو لنقل إنه حائر. فالقرآن الكريم يأمرنا في عشرات الآيات والمواطن بصنع المعروف أو الأمر به والنهي عن المنكر. والمفهوم أنّ المعروف عالمي أو أننا نتشارك مع العالم في معرفته والتشارك بشأنه. وفي طليعة عوالم المعروف المسائل القيمية الكبرى المتصلة بحياة الإنسان وأفكاره وسبل السلوك استناداً إليها، وفي قلب هذه القيم حياة الأسرة وأخلاق العائلة، واهتمام القرآن الكريم مركزيٌّ وأساسيٌّ لهذه الجهة وما يقاربها في الأخلاق الخاصة والعامة. فهل لا يزال هناك معروفٌ عالمي يمكن تحديده والاحتكام إليه في مجتمعاتنا الجديدة ومع العالم الذي صار عميق التأثير في كل كبيرةٍ وصغيرةٍ في حيواتنا الخاصة والعامة؟! هذه المتغيرات الكبيرة هل تركت مجالاً لمعروفٍ عالمي وكيف نفهم ونواجه جهات التأثير التي تهجم علينا في المنازل والأُسَر والطفولة والتعليم ومُثل التربية والتوجه. أعرف أنني لا أقول جديداً، ولا أتحدث عن مجهولٍ من جانب الخاصة والعامة. إنما الملاحظُ أننا ما عُدنا نملك خطاباً أو أساليب للفهم والإفهام في هذه المسائل. لقد صار خطابنا - إذا أمكن تسميته كذلك - قسمين: القسم الثائر الذي يتحدى ويستنكر ويتصدى من دون عروضٍ لبدائل معقولة. والقسم الذي يلجأ للرسوّ في التقليد المعتاد وهو خطابٌ انسحابي متشائم وفضيلته أنه يتشبث بالاستقرار مع يقينه أنه جرى تجاوزه وحوصر إلى حدٍ بعيد. الدول والسلطات ساعدت وتساعد في استقرار الحياة الدينية والشعائرية وحياة الأُسرة وسلاسة التعليم وحقوق المرأة والطفل. لكنّ علماء الدين أفراداً ومؤسسات يكون عليهم أن يواجهوا الجمهور، ويخاطبوه بشأن هذه المتغيرات التي غيّرتْ معالم المعروف والمنكر.
الدين قوةٌ ناعمةٌ وخطابها الإقناعي هو المعتبر وليس الخطاب الاحتجاجي الذي لا يصنع اقتناعاً ولا ينتج رضاً أو سكينة.
المتغيرات تجتاحنا، ولا سبيل للمواجهة بعقلية المؤامرة على طول الخطّ. فكما تدربنا خلال العقود الأخيرة وبالمعرفة والتأهُّل على مواجهة التطرف والإرهاب، وعلى المصير إلى الحوار العاقل والمنفتح، يكون علينا المصير إلى استمرار التأهُّل بالمعرفة لهذه المستجدات في حقائقها وفي وقائعها وإمكاناتها وتأثيراتها في الحاضر والمستقبل. إنّ التأهيل لمخاطبة الجمهور، والتنافس مع جهات الإرشاد والتوجيه، يقتضي تأهلاً معرفياً بالمستجدات وفهماً لكي نتأهل إذا صحَّ هذا التعبير في إنتاج استراتيجيات تحمي وتصنع المبادرات باعتبارنا جزءاً من هذا العالم، لا نقصد إلى مواجهته، بل نتوخى الصيرورة إلى أن نكون ونبقى جزءاً من سلامه وأمنه وتقدمه.
فهل يمكن بالمعرفة العميقة والعقل النيّر أن نصير مع الجهات العالمية والإنسانية إلى إعادة صياغة «المعروف» وإجماعاته ليس من أجل الحماية فقط، بل ومن أجل صناعة الصيغ التي تحفظ إنسانية إنساننا وإنسانية العالم الذي نعيش فيه؟!
إنها بالطبع مهمة كبرى لا يستطيع علماء الأديان القيام بها بمفردهم. لكنّ القادة الدينيين يلعبون دوراً بارزاً في المجال القيمي والأخلاقي. ولست أزعم أن مشكلات المعرفة والفهم، قصوراً أو إنكاراً، قاصرة علينا، لكنّ المسلمين يوشكون أن يكونوا خُمس سكان العالم، وكذلك الكاثوليك المقبلون على شراكة معنا.
وقد تأثرت كثيراً بوثيقة الأسرة الصادرة عن الفاتيكان عام 2019 لما تنم عنه من فهمٍ وشجاعة وإحساسٍ بالمسؤولية. ومثار القلق لدى كثيرين في أوساطنا وأوساط أصدقائنا هذه الكراهية التي تعود للتفجر في أوساط المثقفين من العرب والمسلمين من الغرب - هكذا من الغرب كله (!). والكراهية عجزٌ وسوء تقدير ولا تفيد في مواجهة المشكلات أو الإقبال على اجتراح الجديد، سواء في الخطاب الديني أو الثقافي. لقد مضت علينا زهاء العقود الأربعة في مكافحة التطرف والإرهاب في أوساطنا وتجاه العالم. وكنا نحمل على الانشقاقات في الدين، كما كنت أُدافع عن التقليد الديني باعتباره الدرع الواقي. لكنّ هذا القصور المستشري الذي يعود للاعتصام بالكراهية لا يدع مجالاً للأمل بالخروج من المأزق. فلا بد من المعرفة المحرِّرة. ولا بد من الإرادة المسؤولة. ولا بد من المبادرات الشجاعة.
لا بد من تجديد الخطاب الديني لتكون مهمته الإرشادية الكبرى إعادة تعريف المعروف، والمصير إلى ملاقاة العالم به، بدلاً من نبذه وكراهيته. تجديد الخطاب الديني ليس موقفاً فقط، بل هو إرادة ومبادرة فلا بد من المصير إلى إنجازه اليوم قبل الغد.
GMT 08:32 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
هوامش قمة البحرينGMT 08:31 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
من الميليشيات إلى القبائل: استنبات الثورة وتجريف الهوياتGMT 08:30 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 08:29 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 08:28 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين
لندن ـ عمان اليوم
أعلنت بريطانيا، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ عمان اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيديوتيوب تبدأ اختبار خاصية الرد الصوتي من صناع المحتوى على تعليقات الجمهور
واشنطن - عمان اليوم
تختبر منصة يوتيوب للفيديوهات ميزة جديدة تعزز التفاعل بين صناع المحتوى وجمهورهم، بما يمكن "اليوتيوبرز" من تسجيل مقاطع صوتية كردود على تعليقات الجمهور على فيديوهاتهم. وبحسب صفحة الدعم الفني الرسمية الخاصة بال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©