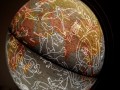الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
في هجاء «كورونا»...
في هجاء «كورونا»...

بقلم : حازم صاغية
قبل أن تكون قاتلة، هي جرثومة مُهينة. لنتذكّر وقتاً غير بعيد، استعاد فيه شبّان الثورات العربيّة وشابّاتها بيت أبي القاسم الشابيّ:
«إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فلا بدّ أن يستجيب القدر».
كانوا يقولون إن في وسعهم أن يفعلوا أي شيء. أنّهم، هم أيضاً، بروميثيوسيّون، يسرقون النار من الآلهة ويعطونها للبشر فتكون حضارة.
«كورونا» جعلتهم يصرفون وقتاً طويلاً وهم يغسلون أيديهم. يبحثون عن سوائل تطهير. أين الصابون؟ خزّنوا ورق التواليت. المهمّ أن نكون معقّمين. أن نتنصّل من العالم.
«كورونا» قالت لنا إنّ السقف منخفض، وعلينا أن نخفض الرأس أكثر. جرحتْ نرجسيّة البشر واعتدادهم بذواتهم. أكّدت لهم هشاشة العالم الذي صنعوه، وأنّ إنجازاتهم في العلوم والطبّ قابلة للتفادي. قالت لمن ظنّوا أنّ العالم بلا حدود: اجلسوا في البيت. العالم هو البيت.
بانقضاض «كورونا»، انقضّ علينا جانب معتم من إنسانيّتنا، جانبٌ يتململ كلّما أضاءت هذه الإنسانيّة. مقابل سعيها للتوحيد والتوسّع، يكشّر العزل عن أنيابه. مقابل اتّجاهها إلى نزع السحر عن العالم يهاجمنا السحر. مقابل الافتخار الإنسانيّ، تُذلّنا الطبيعة.
والوباء، أي وباء، ربّما كان أقلّ الفرسان الأربعة، هو والموت والحرب والجوع، قدرة على التوقّع، وحيال ما يصحبه من غموض نزداد انغلاقاً على وحدتنا. التواصل الذي يبدأ بالمصافحة، ومنها ينشأ التعارف والمعرفة، وربّما الصداقة والودّ، يستدعي الزجر. حتّى يدك نفسها إذا ما ضلّت وصافحت غدتْ عدوّاً لك لا بدّ من تطهيره.
التواصل، عبر المطارات والمرافئ، سبب للهلع. السفر ضارّ. الانتقال ممنوع. وسائل النقل العامّ، التي تناضل الشعوب لامتلاكها، لعنة. الحدود وحدها تستحقّ التقدير، خصوصاً متى كان الوافدون عبرها مهاجرين ولاجئين وغرباء بصفة عامّة. الأفكار القروسطيّة حيال الأجانب المصابين بالأمراض تنبعث رافعة عالياً سيف الحماية، وكاسرة، بقوّة الإغلاق والتسوير، اعتداد المدن الكوزموبوليتيّة. أمّا أن ترفض حضارتنا العقاب ونبذ الآخر، فتردّ عليه «كورونا» بالعزل والحجر بوصفهما إجراءً وقائيّاً لا سبيل إلى تجنّبه. الرحمة لا مكان لها: كبار السنّ وذوو المناعة الضعيفة أمرهم لله. الموت بلا غسل ولا تكفين نصيب من يموت.
بسبب «كورونا» تتعرّض السياسة للتسريح. الآن كلّنا واحد و«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». ثمّ إنّنا في مواجهة الموت، فلا تصرفوا جهدكم على التوافه. ما من شيء يستحقّ الجهد، فيما الأشياء والأنظمة كلّها سواسية حيال «كورونا». أدوات الاعتراض وأمكنته، كالساحة والحشد، مصدرٌ لتفشّي الوباء. نعم، عودوا إلى البيت، فما ينفع ليس سوى حالات الطوارئ والحكم العرفيّ. وفي هذه الغضون يستطيع «الأخ الأكبر» الذي يعالج أحوالنا الاستثنائيّة أن يفعل ما يشاء متذرّعاً بـ«كورونا». ألا ترون أنّها حرب كغير الحروب، تعطّل كلّ شيء حَرفيّاً، وتُشَنّ، من دون جيش، وفي وقت واحد، على قارّات وشعوب ودول بأكملها.
الوعي التآمري يغدو في أشدّه، لا سيما الموجّه منه إلى أميركا التي انتدبها القدر لهذه المهمّة. الوعي العنصري كذلك: اللهمّ أبعدْ عنّا الاحتكاك. فلتُكسر اليد التي تمتدّ إلينا بالمصافحة. ركّزوا على النظافة والروائح. أقيموا الحواجز والجدران. المصاب بيننا باضطراب الوسواس القهري (OCD) حكيمنا الذي عرف مبكراً أنّ الكارثة في طريقها إلينا. أنّ أزمنة الحرّيّة والخيار مجرّد وقت ضائع يستعجل حلولها.
الاقتصادات فلتُدمّر قطاعاً قطاعاً. المسرّحون الذين يعرّضون صفوف البطالة فليتكاثروا. الصين التي كانت تُذكر بوصفها صاحبة الاقتصاد الثاني في العالم، صارت مستشفى يعجّ بالمكممين. إيطاليا، جوهرة الكون، معزولة عن الكون. وإذا طال الزمن بـ«كورونا»، فسيدفع الأفقر والأضعف بيننا الكلفة الأعلى. هؤلاء، بوصفهم الأشدّ معاناة لاحتجاب أجهزة الدولة أو لتفكّكها، ولانهيار أنظمة الحماية الاجتماعيّة والصحّيّة، سيكونون الضحيّة الأولى. وفي بلداننا خصوصاً، حيث المخيّمات واللاجئون والألم الفائض، قد تأتينا «كورونا» على شكل فيضان.
ولسوف ننشغل، في ظلّها، بتاريخ الفيروسات القاتلة، والمقارنة بينها، عن كلّ انشغال. ذاك أنّ أمر اليوم هو التعرّي من الزوائد والإضافات: فلتكن الرياضة من دون جمهور، والطفولة من دون ملعب، والسينما من دون صالة، والأكل من دون مطعم، والقهوة من دون مقهى، واللهو من دون ملهى. بل ليكن الحبّ من دون تماسّ. إنّ أصول الأشياء وتقشّفها الأوّل أو عذريّتها الأولى هي العبادة الراهنة. أمّا الفرار من هذه الكآبة فممنوعة على من كانوا يفرّون بالسفر من الحروب؛ لأنّ السفر متعذّر. النظام مطلق ومغلق.
شيء من بداية العالم إذن مقرون بشيء من نهايته. أمّا نحن فيقتصر تدخّلنا في مجريات حياتنا وموتنا على تعقيم أيدينا وانتظار الدواء - المعجزة من المختبرات.
المشكلة عالميّة والحلّ قوميّ، إن لم يكن بيتيّاً. هكذا يقال. لكنّ من يقولون ذلك يغفلون عن رؤية التعاون الدولي بين حكومات العالم ومختبراته، وعن صيغ قانونيّة جديدة لا بدّ أن تنبثق من هذه التجربة. يتجاهلون أيضاً أولئك الشجعان حول العالم، من أطبّاء وطبيبات وممرّضين وممرّضات، الذين يتصدّون للوباء. أمّا أن ينتج عن القسر والاضطرار عالم جديد أفضل، فلا يغدو كونه عزاءً وتخفيفاً لآلامنا. ذاك أنّ الحرّيّة هي وحدها ما ينتج الأفضل، و«كورونا» نظام عُبودي لا يستحقّ منّا إلا الغضب.
GMT 19:41 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
مجالس المستقبل (1)GMT 19:20 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
البحث عن مقبرة المهندس إيمحوتبGMT 21:09 2024 الأحد ,04 آب / أغسطس
إسقاط حكومة نتنياهو ضرورة وطنية: مَنْ، كيف ولماذا؟GMT 15:28 2024 الأربعاء ,24 تموز / يوليو
انقلبت الصورة الأميركية: بين من كان على "باب السجن" او "باب الخَرَف"!GMT 15:41 2024 الأحد ,14 تموز / يوليو
موسم انتخابى كثيف!بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين
لندن ـ عمان اليوم
أعلنت بريطانيا، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة ـ عمان اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيديوتيوب تبدأ اختبار خاصية الرد الصوتي من صناع المحتوى على تعليقات الجمهور
واشنطن - عمان اليوم
تختبر منصة يوتيوب للفيديوهات ميزة جديدة تعزز التفاعل بين صناع المحتوى وجمهورهم، بما يمكن "اليوتيوبرز" من تسجيل مقاطع صوتية كردود على تعليقات الجمهور على فيديوهاتهم. وبحسب صفحة الدعم الفني الرسمية الخاصة بال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©